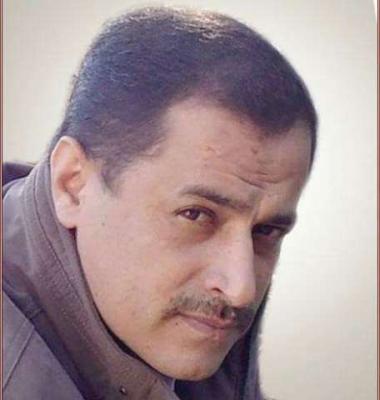لا تقتصر أهمية كتاب (تجديد الفكر العربي) للدكتور زكي نجيب محمود، على كونه يرصد تجربة هذا المفكر الكبير وموقفه من التراث العربي، وكيف شغلته الثقافات الغربية وأبعدته عن تراثه، وما يختزنه من أفكار وقضايا على درجة عالية من الأهمية.
ونقف هنا قليلاً لنتأمل كيف يفاجأ بعظمة تراثه وروائع مضموناته (كانت هناك إذاً ثلاثة أطراف في الحياة الفكرية عن الأقدمين، طرف منها لا عقلاني يعتمد على الغوص إلى الحقيقية الروحانية، مهتدياً بإلهام أو بحدس مباشر، وطرف ثانٍ عقلاني، يستخدم طرائف المنطق النظري في حجاجه، وغالباً ما يتأثر بثقافة اليونان، وطرف ثالث لا يتخذ موقعه في مجال (الفكر) بقدر ما يتخذه في مجال (السلوك) سلوكاً يتفق مع شرعية الدين).
حقاً إنها مفاجأة تلك التي أعادت المفكر الكبير إلى تراثه، وأكدت له أن التراث العربي، كما سبقت الإشارة، مخزون علمي وثقافي، وأن التفاصيل التي وردت بعد ذلك كفيلة بشرح ما أوجزته.
ولا أشك في أن هذه التجربة الواعية العميقة سوف تترك أثرها في الأجيال القادمة وفي العشرات، بل المئات من تلاميذ هذا المفكر العربي، الذي حاولت ثقافة الآخرين أن تسرقه وتبعده عن ثقافته الأم.
وفي إمكان من يقرأ الكتاب من دون أن يكتشف الأسباب، التي جعلته ينكب على دراسة ثقافته وفكر أمته ويجد فيها من الإبداع ما لم يجده في ثقافة أولئك الآخرين.. أليس ذلك ما يقوله؟ (ولقد تعرضت للسؤال منذ أمد بعيد، ولكني كنت إزاءه من المتعجلين، الذين يسارعون بجواب قبل أن يفحصوه ويمحصوه ليزيلوا منه ما يتناقض من عناصره؛ فبدأت بتعصب شديد بإجابة تقول: إنه لا أمل في حياة فكرية معاصرة، إلاَّ إذا بترنا الذات بتراً، وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علماً وحضارة ووجهة نظر إلى الإنسان والعالم، بل إني تمنيت عندئذٍ أن نأكل كما يأكلون، ونجدّ كما يجدّون، ونلعب كما يلعبون، ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون، على ظن مني آنئذٍ أن الحضارة وحدة لا تتجزأ، فإما أن نقبلها من أصحابها- وأصحابها اليوم هم أبناء أوروبا وأمريكا بلا نزاع- وإما أن نرفضها، وليس في الأمر خيار بحيث ننتقي جانباً ونترك جانباً، كما دعا إلى ذلك الداعون إلى الاعتدال.
بدأت بتعصب شديد لهذه الإجابة السهلة، وربما كان دافعي الخبيء إليها هو إلمامي بشيء من ثقافة أوروبا وأمريكا، وجهلي بالتراث العربي جهلاً كاد يكون تاماً، والناس، كما قيل بحق، أعداء ما جهلوا).
إن هذا الاعتراف النبيل لا يأتي إلاّ من مفكر نبيل، لا يخشى من أن يقول الحق ولو على نفسه، وذلك ما عودنا عليه الدكتور زكي في كتاباته المختلفة، أدبية كانت أو فلسفية، وفي مقالاته كما في كتبه، تتجلى هذه الصراحة العميقة، وتؤكد للقارئ العربي أن عليه أن يتابع هذا النوع من الكتابة ليستفيد أولاً، ثم ليعلم أن من تاريخه المعاصر قادةً في الفكر ونماذج يعتد بها عند المقارنة بمفكرين آخرين من لغات وثقافات أخرى.
وكم أتمنى أن يكون لدى الشباب الواعد، قدر من هذه الصراحة والصدق في الاعتراف وجمال التواضع، فكثير هم الشباب المبتدئون المصابون بالغرور، وينقصهم الكثير من الصدق مع أنفسهم ومع غيرهم.
وفي مكان آخر من الكتاب، يقدّم الدكتور زكي اعترافاً آخر يضاف إلى سابقه، وهو: (وأحمد الله أن أتاح لي آخر الأمر هذا الفراغ، كما أتاح لي مكتبة عربية أقضي فيها بعض ساعات النهار، وها هنا نشأ السؤال مرة أخرى، يلح إلحاحاً شديداً هذه المرة: نعم لا بد من تركيبة عضوية يمتزج فيها تراثنا مع عناصر العصر الراهن الذي نعيش فيه، لنكون بهذه التركيبة العضوية عرباً ومعاصرين في آن، ولكن كيف؟ ما الذي نأخذه وما الذي نتركه من القيم التي انبثت في ما خلف لنا الأقدمون؟ وهل في مستطاعنا أن نأخذ وأن ندع على هوانا؟ ثم ما الذي نأخذه وما الذي نتركه من هذه الثقافة الجديدة التي تهب علينا رياحها من أوروبا وأمريكا كأنها الأعاصير العاتية؟
ثم هل في مستطاعنا أن نقف منها هذه الوقفة التي تنتقي وتختار، وبعد ذلك كيف ننسج الخيوط التي استللناها من قماشة التراث، مع الخيوط التي انتقيناها من قماشة الثقافة الأوروبية والأمريكية؟ كيف ننسج هذه الخيوط مع تلك في رقعة واحدة لحمتها من هنا وسداها من هناك، فإذا هو نسيج عربي ومعاصر؟).
ومن جانبي؛ أعترف بأنني صُدمت كثيراً أثناء دراستي الجامعية، وفي أثناء دراستي العليا، بعددٍ من الأساتذة الأفاضل لا ينقصهم التواضع فقط، بل تنقصهم المعرفة كما ينبغي أن تكون لدى أستاذ جامعي، يشكل قدوة في حياته وفي معرفته، وحبذا لو وجد كتاب الدكتور زكي طريقه إليهم لتعلموا منه كثيراً وأدركوا أن المعرفة الخالية من التواضع والمحشوة بالغرور لا تترك أثراً طيباً في عقول قرائها، وقد تشكل وبالاً على المتعلمين الذين ينقصهم الوعي وتنقصهم الخبرة العلمية فيعتقدون أن الغطرسة والغرور هما من لوازم المعرفة.
وللمرة الثالثة أعود إلى كتاب الدكتور زكي لأستنير ببعض إضافاته في هذا المجال:
(لقد تعاورني أثناء محاولاتي الفكرية أمل ويأس، فكثيراً ما كنت ألمح مخرجاً يؤدي بنا إلى حيث نريد أن ننتهي إلى المزيج الثقافي الذي تكون فيه الأصالة، وتكون فيه المسايرة للعصر الراهن، ثم سرعان ما يختفي هذا القبس العابر لينسد أمامي الطريق، ولذلك كثيراً ما وقعت في أقوال متناقضة نشرتها في لحظات متباعدة، فلا يبعد أن يجد قارئ مقالاتي والمستمع إلى محاضراتي العامة وإلى الندوات الفكرية، التي شاركت فيها آراء متعارضة لا يتسق بعضها مع بعض، وذلك لأنني كنت في كل لحظة صادقاً مع نفسي، لكن هذه النفس التي كنت صادقاً معها في تلك اللحظات المتفرقة، لم تكن دائماً على رأي واحد ولا على شعور واحد، فمرة، كما قلت، كانت تظن بأنها قد رأت قبساً من نور، يعين على الخروج من المأزق إلى حيث ينبغي، ومرة أخرى كانت تنظر فإذا الطريق أمامها مسدود، وكنت أنا في كل مرة أطاوعها وأخلص لها..
ففي المرة الأولى؛ كنت أبشر بأن السبيل إلى ثقافة عربية معاصرة قد انفتحت أمامنا أبوابه ونوافذه، وأننا إذا فعلنا كذا وكذا، كانت لنا بذلك فلسفة عربية وأدب عربي وفن عربي وأخلاق عربية وسياسة عربية ونظرة عربية، تميزنا ونعاصر بها الآخرين ممن يعيشون معنا في عالم واحد، وتعترضهم معنا مشكلات واحدة، وفي المرة الثانية يأخذني اليأس فأكتب أو أتكلم لأقول، أن لا مخرج من الأزمة، وأننا بين طرفين متناقضين، ولا حل أمامنا إلا أن نبتر طرفاً منهما بتراً، ليبقى لنا الطرف الآخر خالصاً، فإما أن نتقوقع في ثقافة عربية ذهب أوانها، وإما أن نطوي عنا هذا الثوب العتيق في غير أسف، لنقدَّ لأنفسنا ثوباً جديداً من القماش الجديد).
أليس في هذا الكلام بعض ما يحتاج إليه أساتذة الجامعات، والشبان منهم خاصة؟! فقد طغت ثقافة السرعة والاستعجال، وصارت هي ما يحرك دواليب الحراك الجامعي في كثير من الكليات النظرية في هذا البلد أو ذاك.
* نقلاً عن مجلة الشارقة الثقافية