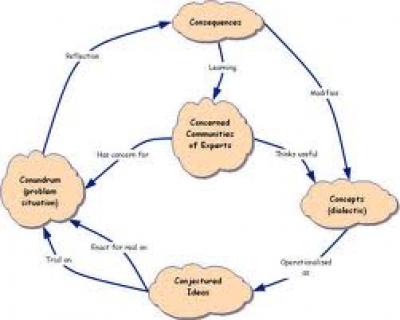
ما من فكرة هددت الطبيعة ومصير الإنسانية مثل فكرة الپراجماتية Pragmatism (الذرائعية أو النفعية)؛ ما من منهجية تفكير وحياة اتخذت طابعًا عالميًّا بقدر ما اتخذت؛ ما من نظرية أحكمت السيطرة على العالم مثلها؛ – حتى بات الصراعُ في العالم يدور ضمنها وليس ضدها.
لا يبدو الصراع الذي يشهده العالم اليوم صراعًا متكافئًا، كما لا يبدو صراعًا بمعنى وجود أطراف كبرى صاحبة مصالح متضاربة، بل يبدو الأمر وكأن هناك سيطرةً عالميةً “مُعولَمة” تقابلُها اعتراضاتٌ “مناطقية” صغيرة، وإنْ عنيفة، هنا وثمة. وقد تبدو أشكال المقاومة كذبابة على ظهر ثور: مزعجة، مؤذية، معيقة، لكنها لا تبدل في حركة الثور أيَّ تبديل يُذكَر أو يُعتَد به. ولكن السؤال غير البديهي المطروح هنا هو: ما طبيعة هذه النظرية التي تسيطر على العالم؟
لم تكن نظرية صموئيل هنتنجتون في صِدام الحضارات مقنعةً للكثيرين من حيث كونُها محرِّكة للتاريخ ومفسِّرة لديناميَّته؛ كما لا يبدو مقنعًا كثيرًا الاعتقادُ بأن مَن يُسمَّون اليوم “المحافظون الجدد” هم وحدهم الممسكون بأعنَّة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العالم بالتالي. ومع أن فرانسيس فوكوياما نفسه تراجع، بشكل أو بآخر، عن نظريته في نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية، إلا أن ذلك كلَّه لم يحجب انتصار الفلسفة الپراجماتية وسيطرتها على الفكر العالمي، بما هي وليدة الفكر الليبرالي.
ولعل “أخطر” ما في هذه النظرية أنها، بشكل أو بآخر، باتت نظرية محاربيها أيضًا، كونها تعتمد منهجية معينة في التفكير والعمل. أجل، ما من نظرية أو فلسفة أو مذهب أو عقيدة أو طريقة تفكير وتدبير إلخ هددت البشرية ومصيرها والأرض – ما عليها ومَن عليها – مثل الپراجماتية، وذلك لكونها نظرية في الحقيقة والمعرفة والسياسة والقيم.
ارتكزت الفلسفة الپراجماتية على مذهب المنفعة، بوصفها غايةً لتحقيق السعادة للبشرية ووسيلتَه، معتبرةً أن الحقيقة – حقيقة أيِّ شيء – هي في مدى منفعتها للإنسان، في مدى فعاليتها وفعلها ونجاحها وتأمينها للشبع البشري؛ كما اعتبرت أن المعرفة هي وسيلة في خدمة العمل ليس إلا: لا قيمة للمعرفة إلا في مدى فعاليتها ومنفعتها.
و”نفعية” المعرفة هذه اجتاحت الجامعات والمدارس والبرامج والمختبرات والسوق والمنافسة والربح وسلَّم القيم الاجتماعي والعالمي. لم تعد هناك أية قيمة لأيِّ شيء بذاته. واعتبار أن القيمة هي ما “ينفع” الإنسان، وإلغاء أية قيمة لباقي الكائنات، هو في الأصل من الأزمة البيئية اليوم، التي تهدد بدورها النوع البشري نفسه أيضًا.
وفي السياسة الپراجماتية أن المعيار الأساسي الذي تُقاس به السياسة هو المنفعة، أي جملة ما ينتج عن العمل السياسي من مصالح. وهكذا تنجح السياسة بقدر ما تتهرب من قيود الأخلاق وتتحرر من أعباء القيم. بذا صارت الپراجماتية “أخلاق السياسة التي لا أخلاق لها”. وإذ تعتمد السياسة الپراجماتية مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” (ماكياڤيللي)، تبيح استعمال أبشع الوسائل، التي باتت تهدد أسُس الحياة على هذا الكوكب – مع العلم أنه ما من غاية أسمى من الحياة.
نظرت الپراجماتية نظرة ازدراء إلى الفلسفات التقليدية التي تنطلق من نظرة معينة إلى الكون وموقع الإنسان فيه والتي لا تخلو من مناحٍ ميتافيزيقية لتصل إلى التجريد. فعلى ذلك بنت الپراجماتية شهرتها، كونها الفلسفة التي لا تهتم إلا بالإنسان، محور الكون وغايته. ولكن هذا الاهتمام الاستثنائي بالإنسان وحياته لم يؤدِّ إلى إلغاء القلق الإنساني حيال الموت، الذي طالما اعتُبِرَ المحرك الأساسي للميتافيزيقا.
وهكذا اعتبر أحد الظرفاء أن “نجاح” الپراجماتية في الجواب على الأسئلة الوجودية بتجنب إشكالية الموت هو بمثابة دعوة إلى تركيب مكيفات في جهنم!
تبدو الپراجماتية نظرية پسيكولوجية أكثر منها فلسفة جديدة: فهي تدعو إلى إتباع نمط سلوكي نفعي دون ربطه بنظرية عامة في الوجود والحياة. إنها تركز على الموجود، لا على أسئلة الوجود، فتبحث عن سعادة الفرد وإشباع رغباته المعيشية اليومية، الآنية والفورية، من دون فتح أيِّ أفق آخر. وهذا ما يفسِّر انتشار ظاهرة استخدام المخدرات على مستوى عالمي، من حيث إنها تؤمن الرضا النفسي الآني، السريع في مفعولة، لكن السريع أيضًا في انتهاء مفعولة؛ كما يفسِّر انتشار الجريمة المنظمة (و”الإرهاب” اسم آخر لها) التي تكفل الانتقام النفسي الآني السريع، وإنْ على قاعدة إزعاج الذبابة الثورية–الجهادية للنظام الثوري (من “ثور” لا من “ثورة”!).
لا يبدو الصراع الذي يشهده العالم اليوم صراعًا متكافئًا، كما لا يبدو صراعًا بمعنى وجود أطراف كبرى صاحبة مصالح متضاربة، بل يبدو الأمر وكأن هناك سيطرةً عالميةً “مُعولَمة” تقابلُها اعتراضاتٌ “مناطقية” صغيرة، وإنْ عنيفة، هنا وثمة. وقد تبدو أشكال المقاومة كذبابة على ظهر ثور: مزعجة، مؤذية، معيقة، لكنها لا تبدل في حركة الثور أيَّ تبديل يُذكَر أو يُعتَد به. ولكن السؤال غير البديهي المطروح هنا هو: ما طبيعة هذه النظرية التي تسيطر على العالم؟
لم تكن نظرية صموئيل هنتنجتون في صِدام الحضارات مقنعةً للكثيرين من حيث كونُها محرِّكة للتاريخ ومفسِّرة لديناميَّته؛ كما لا يبدو مقنعًا كثيرًا الاعتقادُ بأن مَن يُسمَّون اليوم “المحافظون الجدد” هم وحدهم الممسكون بأعنَّة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العالم بالتالي. ومع أن فرانسيس فوكوياما نفسه تراجع، بشكل أو بآخر، عن نظريته في نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية، إلا أن ذلك كلَّه لم يحجب انتصار الفلسفة الپراجماتية وسيطرتها على الفكر العالمي، بما هي وليدة الفكر الليبرالي.
ولعل “أخطر” ما في هذه النظرية أنها، بشكل أو بآخر، باتت نظرية محاربيها أيضًا، كونها تعتمد منهجية معينة في التفكير والعمل. أجل، ما من نظرية أو فلسفة أو مذهب أو عقيدة أو طريقة تفكير وتدبير إلخ هددت البشرية ومصيرها والأرض – ما عليها ومَن عليها – مثل الپراجماتية، وذلك لكونها نظرية في الحقيقة والمعرفة والسياسة والقيم.
ارتكزت الفلسفة الپراجماتية على مذهب المنفعة، بوصفها غايةً لتحقيق السعادة للبشرية ووسيلتَه، معتبرةً أن الحقيقة – حقيقة أيِّ شيء – هي في مدى منفعتها للإنسان، في مدى فعاليتها وفعلها ونجاحها وتأمينها للشبع البشري؛ كما اعتبرت أن المعرفة هي وسيلة في خدمة العمل ليس إلا: لا قيمة للمعرفة إلا في مدى فعاليتها ومنفعتها.
و”نفعية” المعرفة هذه اجتاحت الجامعات والمدارس والبرامج والمختبرات والسوق والمنافسة والربح وسلَّم القيم الاجتماعي والعالمي. لم تعد هناك أية قيمة لأيِّ شيء بذاته. واعتبار أن القيمة هي ما “ينفع” الإنسان، وإلغاء أية قيمة لباقي الكائنات، هو في الأصل من الأزمة البيئية اليوم، التي تهدد بدورها النوع البشري نفسه أيضًا.
وفي السياسة الپراجماتية أن المعيار الأساسي الذي تُقاس به السياسة هو المنفعة، أي جملة ما ينتج عن العمل السياسي من مصالح. وهكذا تنجح السياسة بقدر ما تتهرب من قيود الأخلاق وتتحرر من أعباء القيم. بذا صارت الپراجماتية “أخلاق السياسة التي لا أخلاق لها”. وإذ تعتمد السياسة الپراجماتية مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” (ماكياڤيللي)، تبيح استعمال أبشع الوسائل، التي باتت تهدد أسُس الحياة على هذا الكوكب – مع العلم أنه ما من غاية أسمى من الحياة.
نظرت الپراجماتية نظرة ازدراء إلى الفلسفات التقليدية التي تنطلق من نظرة معينة إلى الكون وموقع الإنسان فيه والتي لا تخلو من مناحٍ ميتافيزيقية لتصل إلى التجريد. فعلى ذلك بنت الپراجماتية شهرتها، كونها الفلسفة التي لا تهتم إلا بالإنسان، محور الكون وغايته. ولكن هذا الاهتمام الاستثنائي بالإنسان وحياته لم يؤدِّ إلى إلغاء القلق الإنساني حيال الموت، الذي طالما اعتُبِرَ المحرك الأساسي للميتافيزيقا.
وهكذا اعتبر أحد الظرفاء أن “نجاح” الپراجماتية في الجواب على الأسئلة الوجودية بتجنب إشكالية الموت هو بمثابة دعوة إلى تركيب مكيفات في جهنم!
تبدو الپراجماتية نظرية پسيكولوجية أكثر منها فلسفة جديدة: فهي تدعو إلى إتباع نمط سلوكي نفعي دون ربطه بنظرية عامة في الوجود والحياة. إنها تركز على الموجود، لا على أسئلة الوجود، فتبحث عن سعادة الفرد وإشباع رغباته المعيشية اليومية، الآنية والفورية، من دون فتح أيِّ أفق آخر. وهذا ما يفسِّر انتشار ظاهرة استخدام المخدرات على مستوى عالمي، من حيث إنها تؤمن الرضا النفسي الآني، السريع في مفعولة، لكن السريع أيضًا في انتهاء مفعولة؛ كما يفسِّر انتشار الجريمة المنظمة (و”الإرهاب” اسم آخر لها) التي تكفل الانتقام النفسي الآني السريع، وإنْ على قاعدة إزعاج الذبابة الثورية–الجهادية للنظام الثوري (من “ثور” لا من “ثورة”!).












