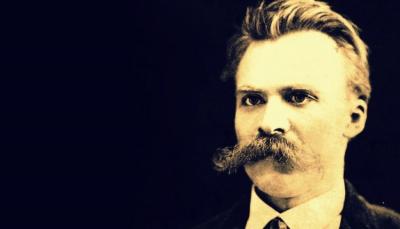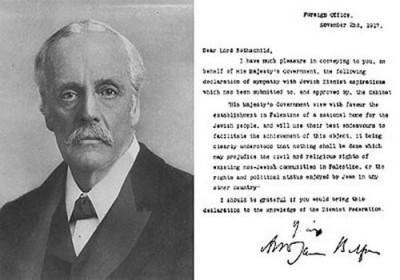إنّ الشّكل الجديد للالتزام المعاصر متجذّر في مبدأ أخلاقي كان جد شائع بداية من نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو الانقطاع الأخلاقي. إنّ عصرنا، المتميّز بالاختفاء شبه التّام لميراث ماركس الروحي حيث أزيحت كبرى المشاريع الثوريّة جانبا، هو عصر الالتزام الموجه نحو النتائج الزّائلة، أو كذلك، هو عصر الحركة النضاليّة المحليّة والمتفرّقة، بعبارة أخرى، تحدث الأمور كما لو أنّنا غير معنيين بمهمة محاربة الشّر في معركة ملحمية ونهائية، سواء في شقّها السياسيّ أو الأخلاقيّ: لم يعد هناك مجتمع علينا إعادته على نمط المبادئ الموضوعية المعرفة بالتحقيق المسمى علمي مثلما لم يعد هناك إنسان علينا تجديده وإعادة تشكيله وفقا لنموذج محدّد سلفا نعتبره مثاليا.في الواقع، لم يعد هناك إنسان أصلا، كما تقول ما بعد الحداثة.
هل يمكننا القول أنّ الشّر قد هُزم، أنّه قد زال؟ لا، بالعكس تماما، هو باق كليّ الحضور، لكنّه منتشر في مجتمع تعوزه مبادرات استئصاله نهائيا، مجتمع عاجز تجاه مراوغاته الماكرة والمتكرّرة. هذا الشّر، إن على مستوى الإنسان أو في خطط إله قتلته الميتافيزيقا (وقتلت معه علم الإلهيات la théodicée) قد حُكم عليه بالديمومة؛ أو بالأحرى، نحن الّذين حُكم علينا بديمومته. معه يظهر سوية، ومنطقيا، الجور المتواصل والواجب المتقطع، أي الجور المنتشر والمستمر (هناك دائما شر يترصدنا) ولكنه ذاك الّذي، بكونه عصي عن الاقتلاع من جذوره، لا يمكن سوى الحدّ منه لفترات موجزة من طرف واجب غير كاف دائما. بعبارة أخرى، نحن عالقون: إنّ مرحلة ما بعد الحرب تزامنت مع انهيار أخلاقي حاد يحضر في آن واحد التفكير في اليوتوبيا – لن نكون أبدا في مستوى الشّر– وفي الله، المحتضر زمن الأنوار، الميّت داخل معسكرات الاعتقال. ومع ذلك، فإنّ واجبنا الأخلاقي لا يخبو بسهولة أمام هذا القرف: إنّه في مواجهته عبثية المستحيل، يترسّخ الآن ضمن ديناميكيّة الانقطاع داعيا المرء لتجديد التزامه، مرّة تلوى الأخرى؛ لا لقمع الجور، ولكن للتّصدي له بشكل دائم من منظور يمكننا وصفه بالمسيحاني (messianique) (الّذي لا يتمّ الوفاء به أبدا، أو الّذي يبقى دائما مدعواَ لأن يُحقُق).
يقترح هذا النّص القصير استكشاف تلك الفكرة عن أخلاقيات الانقطاع انطلاقا من إيمانويل ليفيناس الّذي، دون أن تكون هذه الفكرة حكرا عليه، يظلّ ذا تأثير هامّ بالنسبة لتطورها المفاهيمي. بتعبيرأدق، هذا النّص سوف يناقش طبيعة هذه الأخلاقيات والتّحقق إذا لم تكن هذه الأخيرة، من خلال مداها وخطورتها في عمل المؤلف، ستنتهي في آخر المطاف إلى ضمّ السياسيّ الّذي يسعى ليفياس إلى توجيهه وإلهامه.
لنذكّر أنّ فكر إيمانويل ليفيناس قد تولّد من رماد الهولوكوست. إنّ بشاعة أوشفيتز، بعيدا عن مقاربته بالفلسفة اليونانيّة، قادته نحو الغيرية الخاصّة بتعاليم العهد الأول. أمام رفض النازيين الاعتراف بإنسانيّة الفرد اليهودي، وفي مواجهة كراهيتهم الدفينة لإخوانهم في الإنسانيّة، اختار ليفيناس استكشاف طرائق فلسفة ترتكز على العدالة المطلقة والالتزام اللاّمتناهي. تجاه رفض الآخر، عَرَضٌ من أعراض فكرة “شاملة” تختزل الكل في كلّية واحدة، يقدم ليفيناس طريقة دفاع عن الذاتيّة متجذرة في فكرة اللاّمتناهي: إنّه يقدم غيرية لا يمكن المسك بها قصد كسر المنحى الغربي الّذي يختزل كلّ شيء في المطابق (même).
لنؤكّد أنّ الغيريّة (أو الاختلاف) بيني وبين الآخرين لا تقارن بالغيريّة الّتي نجدها في العالم المسكون، فيما سيسميه ليفيناس العنصر الأساسي (l’élémental). في الطبيعة، يتمّ استغلال الغيريّة الصوريّة من قبل الذّات وتحويلها وفق احتياجاتها الأنانيّة. يجب الالتفات نحو الآخر اللامتناهي، أي الآخرين، بغية تجاوز فئات المطابق والقطيعة مع الكلية. إنّ غيريّة الآخرين المطلقة، على عكس الغيريّة العصريّة الّتي يمكن أن تُفرض عليها سُلطة مّا، غير قابلة للإمساك ولا للتّغيير. وفي صمودها، تقف بكلّ قامتها أمام إمبريالية المطابق؛ الآخر الميتافيزيقي يرفض نسق الكليّة بل إنّه يفجره بعظمته اللامتناهيّة.
يتميّز العالم المسكون بالغيريّة الصوريّة، حيث يحيا الفرد في مأواه، بالحاجة الّتي يمكن، بحكم تعريفها، إشباعها أو التّخفيف من حدتها. الحاجة هذه، هي جوع، عطش، أو تلك الرّغبة الّتي فور تلبيتها تفقد سبب وجودها. والحال كذلك، إذا كانت الرّغبة هي” خواء الرّوح” الّذي يمكننا تكهن طرق تلبيتها، أو على الأقلّ إمكانية ذلك، فإنّ
رغبة الآخر المطلق – الرغبة الميتافيزيقيّة -، من جهتها، رغبة ذات طبيعة مختلفة لأنّها رغبة لا تشبع وتتغذّى على جوعها في حدّ ذاته؛ لأنّها ترغب في ” ما وراء كلّ شيء يمكنه ببساطة أن يتممها”[1]. بهذا فإنّ الرغبة الميتافيزيقيّة هي رغبة غير مهتمّة تماما.
على سبيل المثال، إذا جعتُ، أذهب للخارج، أقطف بعض الفواكه والخضروات، وأعود إلى المنزل لإعدادها ثمّ آكلها. إن الحاجة هنا كانت محددة وكذا الخطوات المتبعة لتلبيتها. بالمقابل، فإنّ حركة الرّغبة الميتافيزيقيّة، تقود الأنا في مسيرة أبعد ما تكون عن التحديد بهذه الطريقة: إن المسارات التي نتخذها قصد تلبية احتياجاتنا تكون في الغالب محددة جدّا وكذا وجهتنا تكون معروفة مسبقا؛ بالعكس من ذلك، فإنّ طريق الرّغبة تقودنا نحو أفق لا يمكننا الأمل لا في بلوغه ولا الإمساك به. لن نصل أبدا للأفق، نحن نتجه نحوه.
إنّ الشّيء الأساسي في حركة الرّغبة لا يكمن إذا في غرض ملموس علينا الوصول إليه، بل في مسار متواصل حيث لا تكون الأنا منقادة سوى بالأفق اللاّنهائي لعظمة الآخرين، منقادة بأثر الآخر (la trace de l’Autre.).إنّ الفضيلة الحقيقيّة المنقذة بالنسبة لموسى والعبرانيين لا تكمن في الرحيل عن مصر؛ لم يكن في استقرارهم في أرض الميعاد أي دلالة على كونهم ساروا كشعب، كأفراد، بل في المسيرة الشّاقة الّتي تكبّدوا فيها محن الصحراء. إنّ رغبة الآخر المطلق تقودنا بالتّالي إلى اتّباع ابراهيم، وليس أوليسيس: إنّ مغامرة الأول، لا نهاية لها، إنّها تفتحنا على المجهول التّام، على ما هو آخر بصفة جذرية؛ مغامرة الثاني تقودنا كذلك نحو ضفاف الاختلاف والغيريّة، لكنّها تأمل في العودة إلى بر الأمان، إنّها تجعل العودة للوطن في الحسبان. وبينما ينتهي المطاف بأوليسس إلى العودة إلى وطنه، ضمن رفاهية العائلي، يغادر إبراهيم إلى الأبد أرض أجداده ليكون بذلك الانفصال كليا.
من خلال الرّغبة الميتافيزيقية، يقدم ليفيناس مفهوم علاقة مع آخر مطلق لا يؤدّي إلى كليّانيّة إلهيّة أو بشريّة، ولكن إلى فكرة اللاّمتناهي. ليس من السّهل، سنتفق مع ذلك، تعيين مصطلح يبحث دائما عن الخروج عن الإطار المرجعي أو اللّغوي الّذي تمّ تداوله ضمنه. ومع ذلك، فهذا بالذات ما يسعى ليفيناس للقيام به مستلهما على الخصوص من تأمّلات ديكارت حول الموضوع نفسه.
إنّ فكرة اللاّمتناهي لدى ليفيناس، تشير إلى علاقة “بين كائن يحتفظ ببرّانيته كاملة تجاه من يُفكر فيه”[2]. نحن لا نملك أبدا فكرة اللاّمتناهي بداخلنا، إنّها تتجاوزنا تماما.لا يمكن للذاتيّة إدماج فكرة اللاّمتناهي من خلال مطابقة ما بين الواقع والفكرة، أي تماثل، لأنّ الــ” مسافة التّعالي لا تكافئ تلك المسافة التي تفصل، في كلّ تمثلاتنا، الفعل الذّهني عن غرضه، كون المسافة الّتي يوجد بها الغرض لا تستبعد- و في الواقع هي تُشرك – امتلاك هذا الغرض، ما يعني التعليق في وجوده[3] .” وهذا هو ما تحقّقت استحالته، في حالة اللاّمتناهي، كون الأمر يتعلق بمفهوم يفيض محتواه في أي لحظة عما يحويه، حتى أنه يُفجّر ما يحويه. إنّ فكرة اللاّمتناهي التي بحوزتنا، بعجزنا عن أن نجعلها مطابقة لوعينا، هي تذكير دائم بأننا لا نملك أية فكرة عمّا يعنيه اللاّمتناهي؛ نحن نعلم أننا لا نعلم ما هو اللاّمتناهي. هذه الفكرة ترتكز على فصل مطلق ما بين الأنا المحايث والآخر البعيد بصفة لا نهائية عن أي إمكانية للتمثّل.
إنّ الأخلاق تحديدا هي تلك الحركة تجاه الآخرين، والّتي تقودنا إلى ما وراء عالم المعرفة ومحاورها نحو تعالي الآخر غير القابل للتمثّل. يقول ليفيناس أنّ العلاقة الأخلاقيّة، هي علاقة دينيّة تحديدا لأنها تفتح على أبعاد المتعالي، على الّذي لا يمكن الوصول إليه، ويخلص إلى أنّ ” النّسق الأخلاقي ليس إعدادا، ولكنّه بلوغ الألوهيّة في حدّ ذاته. كلّ ما تبقى وهم [4]“.
بهذا التّعريف، يمكن لفكرة اللاّمتناهي أن تبدو لنا فكرة مجردة تماما. ومع ذلك، فإنّها لا تقتصر على محاورة وجوديّة أو تحيّر فلسفي. إنّ مكان اللاّمتناهي النّاتج كرغبة ليس ” لا فوق-أرضي( supra-terrestre ) ولا وهميا، بل بالعكس من ذلك إنه المكان الملموس بصفة فائقة لــ ” وجها لوجه” أين أتــ -موضع (me dé-pose) وحيث الآخر يفرض نفسه (s’im-pose) ضمن غيرية نورانيّة، غيرقابلة للتّغيير[5]“.
على عكس وجه أي كائن، يكشف الوجه البشري غيريّة لا تُمسك؛ إنّ الإمبرياليّة العنيفة للمطابق (Meme) تقف فجأة أمام وجه الآخرين غير القابل للتّغيير والّذي يفلت من أي إمساك. لا يمكننا بالتالي استغلال الآخر المطلق كما فعلنا مع أشياء الأساسي (les objets de l’élémental)؛ لا يمكننا تشكيله كما يحلو لنا، ولا تحويله وفق متطلبات إرادتنا، لأنّ كونه لا متناهيا، فإنّه لا يفتأ يفلت من الإمساك، سواء بواسطة الفكر أو بواسطة اليد. إلّا أنّه، إذا كان وجه الآخر يُعبّر بهذه الطريقة عن اللاّمتناهي والمستحيل الوصول إليه فهذا لا يعني أنّه يستبعد أي علاقة بالأنا؛ إنّه لا يمنع العلاقة مع المطابق، ولكنه يُزيح نفسه من هذه العلاقة دوما: إنه يتبرأ من أية علاقة كانت مع الكليّة، إنّه يتجاوز بلا كلل أي نظام كان. إنّ الوجه يكشف الانفصال المطلق ما بين المطابق والآخر.
في نفس الوقت، يسمح أيضا بظهور ضعفه؛ يُعبّر، إن جاز قول ذلك، عن عظمة ضعفه. الوجه العار، هو الوجه الجائع، الّذي يتوسّل وفي نفس الوقت يفرض علينا أن نغذّيه؛ إنّه ضعف المتسول الجائع، الحالة الداعية للشّفقة على الأرملة الحزينة، تعاسة الغريب المنبوذ الّذين، بصوت واحد، يترجوننا ويأمروننا بنجدتهم. إنّ التوسّل لا يتحوّل إلى وصية بالإكراه والّتي يمكن تطبيقها تجاه الأنا في حالة العصيان، ولكن بخوف الله الّذي تُلهمه عظمة وحي الآخرين. الآنا لا ينصاع طائعا مطالب الآخر
نتيجة خوف من انتقامات عدائيّة أو عقوبات شديدة يمكن أن تُسلط عليه جرّاء رفضه، إنّما احتراما يمليه عليه وجه الآخرين. إنّ الوصيّة الآتية من طرف الآخرين تأتي من ارتفاع، إنّها وصية سماويّة. إنّها تستمد شرعيتها من وجه الآخر، معين التعالي الإلهي الّذي لا ينضب، لأنّه وجه فيه شبه بالله.
إنّه في ضعف الوجه الآمر بهذه المسؤولية اللامتناهيّة بالتّحديد يسمع ليفيناس صدى الوصية الأولى لا تقتل أبدا! إنّ النّهي الّذي يعارٍض به تعالي الوجه إمبرياليّةَ المطابق ليس مقاومة جسديّة. إنّ الآخر يفلت من قبضة الأنا، ليس لأنّه قادر على استعمال قوّة جسديّة مقابل تلك القوّة الّتي تبدي له عنفا، بل لأنّ وجهه يشير تجاه اللاّمتناهي، تجاه غير القابل للوصف وغير القابل للتمثّل؛ الوجه يستعمل مقاومة جليّة للتصدي لإرادة قوّة الأنا. إنّ وجه الآخر يعرض علينا غيرية تقاوم كلّ التّحولات: يمكننا أن نجعل من الخشب قطعة ورق، يمكننا إذابة المعدن الخام لتحويله معدنا نقيا، لكنّنا لا نستطيع ممارسة سلطة على هوية الآخرين، لأنّ الوجه تحديدا ليس قابلا للتّعريف، لا يمكنني الاستيلاء عليه كونه، بحكم تعريفه، غير قابل للمسك ولا للتّغيير. بهذا، لا يمكنني إنكار غيرية الآخر اللاّمتناهيّة، ولكن يمكنني رفض احترامها. ولهذا السبب كان النّهي عن القتل أخلاقيا وليس مفروضا بالقوّة. لا يوجد سوى عيني الآخر الــ “غير محميتين تماما” ما يُبدي مقاومة مطلقة تجاه الاستغلال وتجاه الامتلاك واللتين تدعوان إلى المسؤوليّة اللامتناهيّة.
إنّ العدالة، وفقا لليفيناس، تُقام تحديدا ضمن فعل الوجه مقابل الوجه (le face-à-face) مع الآخرين والّذي يثير مسؤولية الأنا. إنها تنبثق من الوضع الأخلاقي، أي من اللّقاء مع الآخر باعتبارها تعاليا غير قابل للقول والّذي أدين له بكلّ شيء. تكمن مهمة العدالة في الاعتراف بالآخر كسيّد، وهذا ما يفترض استقامة الوجه مقابل الوجه. إنّ اعترافي بالآخر كآخر بصفة مطلقة، رافعا نفسي في مستوى ارتفاعه، ذاك الارتفاع الخاصّ به والّذي يحتم عليّ، من خلال ضعفه، إخلاصي الكامل له، سيؤسّس العدالة الأخلاقيّة.
بالتّالي، إذا كانت العدالة تُعرّف بأنّها الاستجابة الملائمة لفعل الوجه مقابل الوجه مع الآخر، وأن هذا الوجه نفسه يوحي باللاّمتناهي، يمكننا إذن أن نخلص إلى أنّ العدالة المقدمة للنّاس تُنتِج ” الفجوة الّتي تقود نحو الله”[6].هذا لا يعني أن وجه الآخر هو تجسد الله، بل بالأحرى عن طريق هذا الوجه سيظهر ذاك الارتفاع حيث يتجلى الله. ” إلها لامرئيا، يقول ليفيناس، هذا لا يعني فقط إلها غير قابل للتخيل، بل إلها يمكن الوصول إليه في العدالة”[7] وبالتّالي، فالعلاقة بين الموجود الخاص والله تتطابق تماما مع العلاقة ما بين الموجود الخاص والآخرالميتافيزيقي: في كلتا الحالتين، وحدها العدالة، أي العطية والخير كاستجابة للنّداء المعبر عنه من خلال وجه الآخرين، تسمح – وتنتج – العلاقة. إنّ الفرق إذن بين الله والآخر لا يكمن ضمن علاقة التّعالي الّتي يحافظان عليها مع الأنا والّتي يكتسبان من خلالها صفة الإطلاق باستمرار. في الواقع إنها تتمثل في أنه، إذا كان الآخر والله غير مرئيين كلاهما، فإنّ الآخر يُعتبر ذاك “اللامرئي المرئي” الّذي يمكننا إعطاؤه. الآخر الميتافيزيقي، ليس لا تجسيدا لله ولا الصورة البشريّة لحضوره فينا، إنّه شبيهه؛ إنّ وجه الآخرين لا يُمثل الله، بل يُشير إلى اللاّمتناهي، إنّه تجلي الوصية السماويّة باحترام الأخ، بأن نحقّق العدالة تجاهه.
إنطلاقا من هذا يُطرح السّؤال: إذا أنا أعطيت كلّ شيء للغير، ماذا سيتبقى لي لأقدمه للآخرين؟ إذا كانت العدالة تتمثل في منح الآخر كلّ شيء، كيف سيكون مصيرها إذا ما أصر عليّ الطرف الثالث كذلك احترامه وخيريتي؟ إن العلاقة الأخلاقيّة توجب علي أن أكون مسؤولا مسؤولية تامة تجاه الآخر؛ كيف يمكنني، وفقا لحضور الطرف الثالث، الحدّ من مجهوداتي تجاه أحدهم حتّى أتمكن من إعطاء الآخر؟ بعبارات أخرى، كيف لي أن احسب ما هو غير قابل للحساب وأن أقارن غير القابل للمقارنة؟
إنّ اقتراح ليفيناس، رغم أنّه اقتراح غير قابل للتحقق (utopique)، يبدو واضحا: الآخر اللاّمتناهي – برّانية مطلقة وغير قابلة للمسك – يأمرني أن أكون عادلا معه. وقد سبق ولاحظنا أنّ العدالة الأخلاقية تأخذ معنى خاصا إلى حد ما لدى ليفيناس. تتمثّل أولا وقبل كلّ شيء في تلك الاستجابة التي تصدر عن الأنا تجاه نداء الآخرين. العدالة، هي الأنا الّذي يمنح كل شيء للآخر، إنّها الفرد الّذي يخلص إخلاصا تاما تجاه الآخرين، إلى حدّ التضحية بسعادته، بل حتّى حياته.
غير أنّ الآخر ليس وحيدا أبدا، يحذرنا ليفيناس. إنّ وجه الآخر حينما يطالب بخدمته يؤكد كذلك حضور الطرف الثالث، إنّه يفتح نحو الإنسانيّة جمعاء. الطرف الثالث ” يرى الأنا في أعين الآخرين (…)”[8] ويطالب بدوره تفانيا مطلقا. انطلاقا من ذلك، لا يمكن التعبير عن المسؤوليّة الأخلاقيّة بنفس الطريقة: لا يمكن للأنا أن يُعطي كلّ شيء للآخر حذرا من تجاهل الطرف الثالث؛ إنّه عاجز عن التفاني تفانيا كليّا – وبصفة فريدة – تجاه الغير دون إهمال الآخرين الّذين يحيا معم كذلك ضمن مجتمع. إنّ أعين الغير تناديه ليمدد مسؤوليته اللامتناهيّة للجميع.
إنّ السياسي لدى ليفينياس هو بالتّحديد فضاء التّساؤلات ذاك حيث تُطرح المطالبة المزدوجة بمسؤوليّة لامتناهية تجاه الآخر المطلق وحضور طرف ثالث مطالب بنفس التفاني. إنّه ليس إجابة جاهزة، ولكنّه تساؤل عن معنى المسؤوليّة الفرديّة مقابل الغير ومقابل الآخرين، وعن التوفيق ما بين الواجب الأخلاقي والقيد السياسي: ” ماذا عليّ فعله؟ ماذا فعلا لبعضهما البعض؟ من منهما أقدمه أولا في سلم مسؤوليتي ؟ ماذا يُمثل هؤلاء، الآخر والطرف الثالث، الواحد بالنسبة للآخر؟ ولادة السّؤال “[9].
إنّ تحقيق العدالة تجاه الآخرين، هي خدمتهم “حتّى النّهاية” : العدالة الأخلاقيّة تؤدّي بالفرد نحو الأفق الّذي لا يمكن الوصول إليه للبرانية اللامتناهيّة. إن لمح الطرف الثالث لا يعني، بالنسبة للأنا، تغيير الاتّجاه: العدالة السياسيّة، هي الالتزام
على نفس الطريق المرسوم من طرف الحركة الأخلاقيّة – هي اتباع أثر الآخر – ولكنّها أيضا ملاقاة آخرين من الآخر في طريقي والّذين سيوقفونني وينادونني بدورهم، متسائلين بحضورهم عن كيفية تصرفي، عن الطريقة الّتي تُمارس بها مسؤليتي اللّامتناهيّة حتّى ذلك الحين. إنّ الذاتيّة لا تشيح بوجهها أبدا عن الآخر المطلق، مادامت في عينيه بالذات سترى الطرف الثالث. لكن حضور الطرف الثالث يعني أنّه من ثمّ فصاعدا يتوجّب إعادة صياغة العدالة بطريقة أخرى: بينما تُعطى العدالة الأخلاقية كليّة للآخر، فإنّ العدالة السياسيّة تأخذ في عين اعتبارها الطرف الثالث؛ الأولى مستحيلة عقلانيا، والثانية غير عادلة أخلاقيا.
الآن، إنّ السياسة – الّتي تتطلّب مقارنة غير القابل للمقارنة – تقتضي وجود مؤسّسة غير شخصيّة تجبرني على إعادة توزيع مجهوداتي حتى يستفيد منها الجميع. وعلى الدولة العادلة أن تسمح لي بتوسيع مسؤوليتي الأخلاقية لتشمل جميع من أشاركهم. غير أنّ هذا الهاجس تجاه الكلّي يمنع الدولة من الاعتراف بشكل كامل بفردانيّة الوجه. وإن المنطق العقلاني يتطلّب موضوعيّة تبقى عمياء قبالة الخصوصيّة الفرديّة. وبالتّالي فإنّ أبشع القساوات يمكنها أن تنجم عن ضرورة النظام المعقول. إنّ التدابير المتخذة ضدّ عنف المستبد، سيتحمّلها الفرد كاستبداد آخر. ومن هنا كانت خلاصة ليفيناس المذهلة هذه: ” ولكن السياسة المتروكة لنفسها، تحمل في طياتها طغيانا. إنّها تشوه الآنا والآخر اللذين أثاراها، لأنّها تحكم عليهما وفقا لقواعد كونية وفي الآن نفسه، كما لو كان الحكم غيابيا “[10].
من ثمّ، كيف يمكن توجيه المؤسّسة العقلانيّة نحو العدالة الأخلاقيّة إذا كان للسياسي ميلا نحو قيادتها تجاه القوننة اللاشخصية (le légalisme impersonnel)؟ كيف يمكن تجنيب الدولة من الغرق في الاستبداد إذا كان من طبعها الميل نحو جعل الاجتماعي شموليا؟ بتذكيرها مرارا وتكرارا أن شرعيتها لا تنبع من ذاتها وإنّما من المسؤوليّة الأخلاقيّة الّتي تؤطّرها. من المؤكّد أنّ القانون العقلاني ينجح في حماية
حرّيتنا وفي فرض تبادل مسؤوليتنا، ولكنّه في حدّ ذاته مصاب بعدوى طموح استبدادي: عدوى الهيمنة على الاختلاف وشمل الغيريّة. وحتّى تبقى المؤسّسة الموضوعيّة عادلة، وحتّى لا ينفصل السياسي عن الأخلاقيّ متقوقعا حصريا على منطقه، يجب تذكير الدولة بين الفينة والأخرى أنّ واقعها ليس مستقلا عن الفرد الّذي هو في خدمتها؛ وأنّها في حدّ ذاتها مديونة تجاه سلطة تسبقها وتتعالى عليها.
لتحقيق ذلك، يجب أن نقحم شيئا مختلفا جذريا، شيئا آخر مطلقا. لتوجيه الدول العقلانيّة، يجب مجابهتها بغيريّة غير قابلة للمسك والّتي تستدعي التفاني المطلق: وجه الآخر اللاّمتناهي غير القابل للوصف. ليس هناك سوى تعالي الغير ما يمكنه إعادة التّفكير في آلية عمل منطق الدولة. إذا كانت الدولة تمثّل هذا المنظور الخارجي الّذي يحكم على المجتمع السياسي باسم النّظام الكلي، فما هي السّلطة الّتي بمقدورها تذكير الدولة بالعودة إلى الجادّة إن لم يكن وجه الآخر غير القابل للمساومة والآمر بالاحترام.؟ أية هيئة تستطيع الحكم على النّظام السياسيّ إن لم يكن ذاك الخارج المتعالي على البرانيّة الخاصّة للدّولة؟
أخيراً، ليست قوّة القيد القانونيّ هي الّتي يعارض بها ليفيناس عملية تحويل الإجتماعي إلى شمولي، ولكن تحديدا عظمة الوجه الفائض عن الشموليّة. هناك عاملان يشرحان ظهور الدولة: ضعف الفرد – لا يمكنه أن يحارب بمفرده ضدّ محن الاستبداد؛ وعجز الفرد عن تمديد واجبه الأخلاقي ليسع الجميع- إنّها الدولة من يجعل من مسؤوليتي اللامتناهيّة حكيمة وذلك بتعميمها. وتأتي المؤسّسة السياسيّة لتستكمل حدود الآنا؛ تأتي لمساعدة الفرد أداء مهام ليس بمقدوره انجازها بمفرده. من المفارقات، أنّ هذا الفرد نفسه، الضّعيف وذا الأحاسيس، من يقف ضد الطموحات الإمبرياليّة للدولة. يبقى الضعف البشري أقوى حصن ضد الاستبداد. لماذا يتوجّب رجّ الهيمنة السياسيّة رجّا عنيفا؟ لماذا انزياح الدولة الجذري عن المركز هذا والّتي أصبحت الآن ترى شرعيتها تابعة للمتطلبات الأخلاقيّة؟ لأنّ خمسة عشرة قرنا من المسيحية ومن الفلسفة الكلاسيكيّة لم تعرف كيف تتجنب أهوال الهولوكوست. هذا الاستخلاص المؤلم يلزمنا يأمرنا بإخراج طرق التّأمل حول العدالة الإنسانيّة للعلن ويأمرنا بالتّفكير بطريقة مختلفة في العلاقة الاجتماعيّة.
إنّ حياة ليفيناس مهيمنٌ عليها ” من طرف الحسّ الداخليّ وذكرى الرّعب النازيّ”[11]، إنّ نقده للشمولية، الّتي يكرّس لها أعماله الفلسفيّة، ناجم ” عن تجربة سياسيّة لم ننسها بعد”[12]، تجربة غير قابلة للتسمية والّتي تضعنا في مواجهة حالة الاستعجال القصوى للأمر القطعيّ التّالي: يجب أن لا يتكرّر أوشفيتز. في مقابل هذا الأمر الحيويّ، لم يجد ليفيناس الحلّ في تلك السياسة المتيقنة من منطقها، بل في تلك الأخلاق القلقة على مسؤوليتها. وكأنّ ما كلّف اليهودي حياته، هو تفرّده، وأنّه لإنقاذ البشريّة من الجنون النازيّ كان يجب أولا التّذكر أنّ وراء الاسم، وراء الثّقافة ووراء اللّون، ثمّة وجه بشري يحاورني ويترجّاني أن أخدمه؛ وجه، في ضعفه، يحضر كل عنف ويرفعني إلى مستوى المسؤوليّة.
أن تكون الأخلاق هي التوجّه الأوّل للسياسي هذا لا يُلغي أهميّة القانون العقلانيّ. يُكنّ ليفيناس إعجابا لا يمكن إنكاره بالإرث الفلسفي لليونان. لكنّه يقدّم غيريّة غير قابلة للاستيعاب والّتي كما النّبي، تدين تجاوزات الملك بعرضه على الإرادة الإلهيّة؛ إنّها برانيّة تُزعج النّظام الكوني حين تحاكمه انطلاقا من ارتفاعه اللاّمتناهي. يُدين النّبي دون مواربة انزياحات سلطة الملك، فهو يواجه ما بين الإنسانيّة قاطبة وتلك الحقيقة المؤلمة الّتي لا بدّ منها: أنّ السياسي هو عدم كفاية. إنّه لا يُعطي أبدا ما يكفي، إذا ما احتفظ للطّرف الثّالث بقليل مما يُعطي، فإنّ هذا سيقلل من حقّ الآخر؛ إذا ما غذى الآخر، فإنّ الطرف الثّالث سيجوع. ناهيك عن عدم استطاعته أن يُترك وحيدا مع نفسه، خشية أن يضل الطريق. يتوجب علينا مساندته، التّدخل من حين لآخر لإعادته إلى الجادة، تلك الّتي تتبع أثر الله. يعلمنا النّبي أنّ السياسي لا يكفي نفسه، وأنّه افتقار مزمن، وأنّنا إذا ما رغبنا في تجاوز حدوده، توجّب علينا الالتفات نحو “ديانة” تكون أكثر تطلبا بشكل لا متناهي: إنّها العدالة الأخلاقيّة الّتي تُلزمني أن أكون في خدمة الآخر. إنّه يعلم أخلاقا تقطع دابر الشّر المستشري باسم عدالة قلقة على الدّوام وواجب غير مؤدّى أبدا. ماذا يعلمنا ليفيناس عن الالتزام السياسيّ؟ أنّه يُعرّضنا لمواجهة ما هو أكبر من ذواتنا. أنّه يحدث تحت رعاية أخلاق تقطع، بطريقة خاطفة ومن حين لآخر، المنطق الاستبداديّ للسياسيّ. ويذكرنا أنّ الالتزام ينتشر ضمن وباسم إنسانيّة مشتركة، نسعى نحن للاعتراف بها في خصوصيتها و تنوع عباراتها.